هل يمكن تحويل مكافحة الفقر لعلم تجريبي؟
– بعيدًا عن حقيقتيِ الموت والضرائب، ثمة حقيقة أخرى تكاد تكون من مسلمات الحياة، على الأقل في أروقة كليات السياسات العامة وصناعة القرار العالمي؛ ألا وهي الحديث الذي لا ينقطع عن كيفية مساعدة الأشخاص الأشد فقرًا في جنوب الكرة الأرضية.
– هؤلاء الذين يعيشون على أقل من دولار وربع يوميًا، والذين يبلغ تعدادهم 1.3 مليار إنسان، وأطلق عليهم الاقتصادي التنموي بول كولير لقب “المليار الأدنى”.
– تحولت هذه القضية الإنسانية على مدى عقود، إلى ساحة صراع فكري محتدم، تصطف فيه جيوش من الخبراء مسلحين بنظريات كبرى، كلٌ يدعي امتلاكه للحل السحري الذي سينتشل البشرية من وهدة الفقر.
– في أحد المعسكرين، يقف الأكاديمي اللامع جيفري ساكس، داعيًا إلى ضخّ مساعدات أجنبية هائلة كطوق نجاة فوري.
– وفي المعسكر المقابل، ترفع الاقتصادية الزامبية دامبيسا مويو لواء “التجارة لا المعونة”، محذرة من أن المساعدات ليست إلا مخدّرًا يعمق الجراح ولا يعالجها.
– وبين هذين القطبين، تظهر أفكار أكثر جذرية، مثل دعوة بول رومر لإنشاء “مدن مستأجرة” كواحات للحكم الرشيد والنمو.
– في خضم هذا الصخب النظري، يبدو أن كل كتاب جديد في مجال التنمية الدولية محكوم عليه بأن يقدم “حلًا جذريًا” آخر، وأن يستهل صفحاته بالعبارة المبتذلة “النظام القائم فاشل”.
– وسط هذا القدر من التشكك، يأتي كتاب “اقتصاد الفقراء: إعادة تفكير جذرية في طريقة محاربة الفقر العالمي”، من تأليف أبهيجيت بانرجي وإستر دوفلو.
– والذي فاز بجائزة “فاينانشيال بوست” المرموقة، ويضم بين دفتيه أفكارًا مختلفة تمامًا، قد تبدو متواضعة في ظاهرها، ولكنها أشدّ ثورية في جوهرها.
هدم النظريات الكبرى: عبقرية الإجابة المتواضعة
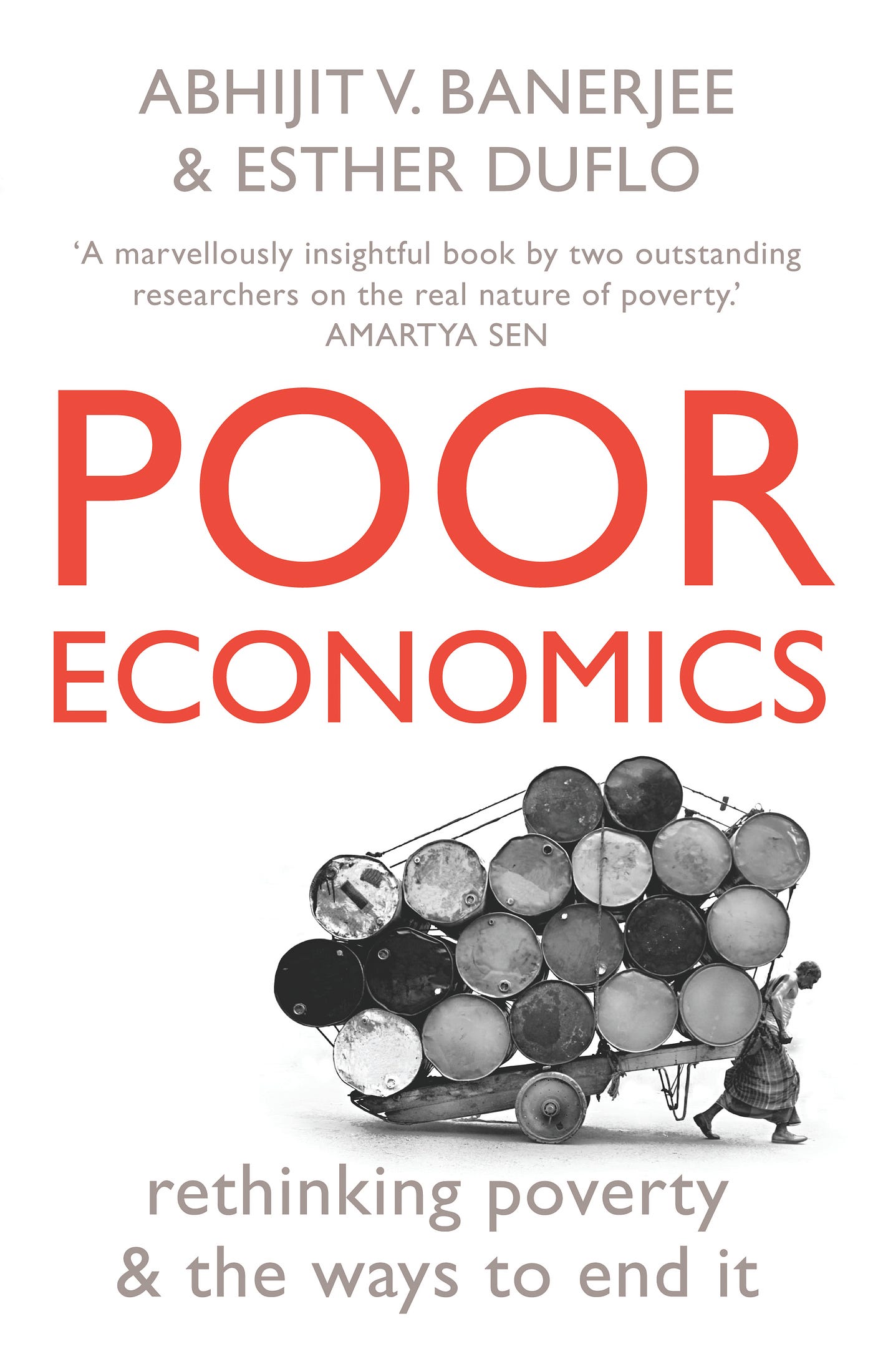
– أول ما يدهشك في “اقتصاد الفقراء” هو تواضعه الفكري. يضع المؤلفان، الحائزان على جائزة نوبل في الاقتصاد، نفسيهما خارج حلبة المصارعة الفكرية بين معسكري “المساعدات” و”التجارة”.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
– فعندما يواجهان السؤال الأزلي “ما الحل الأفضل لمساعدة الفقراء؟”، تأتي إجابتهما بسيطة ومربكة في آنٍ واحد: “الأمر نسبي ويعتمد على السياق”.
– للوهلة الأولى، تبدو هذه الإجابة تهربًا أكاديميًا مألوفًا. لكن في عالم التنمية المعتاد على الحلول الشمولية الجاهزة، كانت هذه العبارة بمثابة نسف للمسلمات.
– يؤكد بانرجي ودوفلو بقوة أن استراتيجيات محاربة الفقر غالبًا ما تُصمم في مكاتب مكيفة في واشنطن أو جنيف، ثم تُفرض كحل عالمي موحد، متجاهلة أن الفقر ليس مرضًا واحدًا يتطلب علاجًا واحدًا، لا سيّما وأنها تتجاهل البنى التحتية الدقيقة التي تصل إلى المستخدم النهائي نفسه؛ أي الإنسان الفقير الذي صُممت هذه الاستراتيجيات من أجله. فالفقراء ليسوا كتلة صماء متجانسة، وأي استراتيجية تتجاهل هذا التنوّع محكوم عليها بالفشل.
المختبر الميداني: ثورة المنهج العلمي في محاربة الفقر
– إذا كانت فرضية الكتاب متواضعة، فإن المنهجية التي يقترحها هي قمة الراديكالية، وهنا تكمن الثورة الحقيقية.
– يقترح المؤلفان مقاربة جديدة تمامًا لاختبار فعّالية برامج مكافحة الفقر، وهي مقاربة مستوحاة من عالم الطب: التجارب العشوائية المنضبطة.
– الفكرة بسيطة ومذهلة في آنٍ واحد. تمامًا كما يتم اختبار دواء جديد، حيث تُعطى مجموعة من المرضى الدواء الحقيقي، بينما تُعطى مجموعة أخرى دواءً وهميًا، لمقارنة النتائج بدقة علمية، يطبق بانرجي ودوفلو المبدأ ذاته على السياسات الاجتماعية.
– على سبيل المثال، هل توزيع الناموسيات مجانًا أكثر فعّالية من بيعها بسعر رمزي لمكافحة الملاريا؟ هل برامج التحويلات النقدية المشروطة تحسن من تعليم الأطفال؟ بدلاً من التنظير، يذهبان إلى الميدان ويجريان التجربة.
– هذا المنهج هو ما كرّس له المؤلفان حياتهما المهنية من خلال تأسيس “مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر”، الذي أصبح المحرك العالمي لهذه الثورة المنهجية، وقدم للعالم كنزًا من الأدلة القائمة على التجربة، لا على الأيديولوجيا.
ما وراء الأرقام: فهم عقلية الفقير
– إذا كان المنهج العلمي هو أحد جناحيِ الكتاب، فإن الجناح الآخر هو تركيزه المطلق على بطل القصة المنسي: الشخص الفقير أو المعدم.
– يغوص الكتاب عميقًا في دوافع الفقراء وقراراتهم التي تبدو غريبة ومحيرة لأولئك الذين ينظرون إليهم من بروجهم العاجية.
– هنا، يتحول الكتاب ليصبح أشبه بنسخة تنموية من كتاب “الاقتصاد العجيب” الشهير؛ فهو يطرح أسئلة جريئة وصادمة: لماذا يشتري من يعيش على أقل من دولار يوميًا جهاز تلفاز بدلاً من طعام مغذٍ؟
– أو لماذا يقترض من المرابين بفوائد فاحشة ويتجاهل قروض البنوك الميسرة؟ ولماذا ينفق على أدوية علاجية باهظة ويتجنب الوقاية الرخيصة؟ باختصار، لماذا يتخذ أفقر الناس في العالم القرارات التي يتخذونها؟
– الإجابة التي يقدمها الكتاب، والمدعومة بتجارب لا حصر لها، هي أن الفقراء ليسوا أشخاصًا غير عقلانيين أو بحاجة إلى وصاية، كما تفترض الكثير من السياسات التنموية.
– بل على العكس تمامًا، إنهم عقلانيون إلى أقصى درجة، لكنهم يتخذون قراراتهم ضمن هيكل من الحوافز والقيود والسياقات الاجتماعية التي تختلف جذريًا عن تلك التي يعيشها صانعو السياسات.
أسطورة التمويل الأصغر: بين الوهم والحقيقة

– يقدم الكتاب مثالًا صارخًا على منهجه عبر دحض أكذوبة “التمويل الأصغر”، الذي تم الترويج له كحل سحري لمشكلة الفقر، لدرجة أن الأمم المتحدة أعلنت عام 2005 “عامًا للائتمان الأصغر”.
– صحيح أن الفكرة تبدو رائعة على الورق: قروض صغيرة بفوائد منخفضة لتشجيع ريادة الأعمال والاكتفاء الذاتي.
– لكن تجارب بانرجي ودوفلو الميدانية كشفت عن حقيقة أكثر تعقيدًا. نعم، التمويل الأصغر أفضل من الاقتراض من المرابين، لكن معدلات استخدامه ظلت منخفضة بشكل محير.
– إذن، لماذا يفضل الفقراء اللجوء إلى مقرض محلي يفرض عليهم فوائد باهظة؟ تكمن الإجابة في السياق الاجتماعي، لا في جداول البيانات الاقتصادية.
– وجد المؤلفان أن برامج التمويل الأصغر تفرض جداول سداد صارمة وغير مرنة، بينما يظل المقرض المحلي، رغم جشعه، جزءًا من الشبكة الاجتماعية، يمكن التفاوض معه، ويتفهم الظروف الطارئة.
– إنه يقدم مرونة لا تقدر بثمن بالنسبة لشخص يعيش على حافة الهاوية. هذه هي نوعية البصيرة العميقة التي يقدمها الكتاب.
إعادة تعريف المعركة: من الغطرسة إلى الإنصات
– في نهاية المطاف، لا يُعد “اقتصاد الفقراء” مجرد نقد للنظريات الكبرى، بل هو دراسة عميقة ومؤثرة للتجربة الحية لمن يعيشون في فقر مدقع.
– إنه كتاب إنساني، يجبرك على إعادة التفكير في كل مسلماتك. قد لا تكون ادعاءاته جذرية كما يوحي عنوانه، لكن تأثيره أعمق من ذلك بكثير.
– إن الإرث الحقيقي لهذا العمل لا يكمن في تقديم حلول جديدة، بل في تغيير طريقة طرح السؤال. لقد نقل المعركة من “غطرسة الخبراء” الذين يملكون الإجابات، إلى “تواضع الباحثين” الذين يتقنون فن الاستماع والاختبار.
– وهو يذكرنا بأن الخطوة الأولى لمساعدة الفقراء بصدق، هي أن نبدأ بفهمهم كبشر عقلانيين، لكل منهم قصة، ومنطق، وكرامة.
المصدر: بابلك بوليسي آند جوفرننس ريفيو
للمزيد من المقالات
اضغط هنا

التعليقات